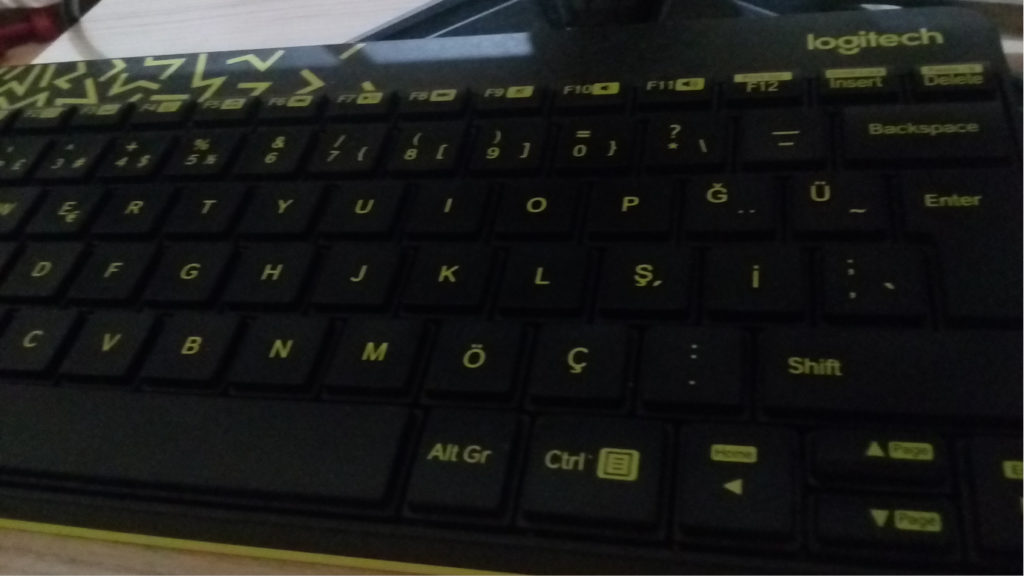مساق Vehicular Networks هو أحد المساقات (Courses) التي آخذها في الماجستير هنا في الجامعة وهو المساق الوحيد في هذا الموضوع في كامل تركيا وواحد من ضمن 10 مساقات أخرى على مستوى العالم. أرانا الدكتور بضعة حلول سريعة لمشكلة السيارات ذاتية القيادة وكيف أننا في المستقبل سنعمل على بروتوكولات شبكة تساعد تلك السيارات على التواصل مع نقاط Access Point عند إشارات المرور للقيام بأشياء مختلفة (التواصل مع السيارات الآخرى، ضبط ترافيك السيارات وتشغيل وتعطيل الإشارات الحمراء تبعًا لذلك، الإبعاد لسيارات الإسعاف تلقائيًا إن كانت قادمة… إلخ). كل هذا شيء جميل ويعتبر آخر ما توصّل له العلم في المجال (state-of-the-art)، ولكنني توقفت وقلت يا سبحان الله كيف يحل الناس المشاكل الخطأ.
شعوري وأنا أشاهد تطبيقات هذه المشكلة وكيف أنهم يعتمدون على الأقمار الصناعية والتمييز البصري والشبكات اللاسلكية السريعة وتقنيات الذكاء الصناعي ووو…. كل هذا فقط من أجل إدارة المرور، ولم يفكّر واحدٌ منهم أنه يحل مشكلة كان يجب ألّا يعمل على حلّها أصلًا. حياتنا اليوم في المدن لأشبهها لك هي كمثل امتلاك كل شخص لطائرة صغيرة في بيته، ومدرّجات في كل أنحاء المدينة وناطحات سحاب لا شيء لها سوى أن تراقب مرور هذه الطائرات بين الملايين من الناس الذين يستعملونها داخل المدينة، مع حاجة كل واحدٍ منهم لشراء طائرته ومراقبة مكوّناتها وأعطالها، ومئات من الأشياء الأخرى التي سنخترعها لنتمكّن من الحصول على بضعة ملايين طائرة صغيرة تطير داخل المدن. ثم تجد المهندسين والعلماء منهمكين في اختراع الحلول هنا، دون أن يفكّروا لماذا بحقّ الله تطير الطائرات أصلًا داخل المدينة؟
جامعتي تبعد بالضبط 8.5 كيلومتر عن منزلي، ولكنني بحاجة إلى استغراق 35 دقيقة في المواصلات ﻷصل إليها رغم أنني من المفترض أن أكون قادرًا على الوصول إليها في 10 دقائق بالسيارة. النقل العمومي مقرف وطويل ومتعب، طبيعي إذًا أن يشتري الناس سيارات ليتمكّنوا من الذهاب أينما يشاؤون بسرعة.
لكن المشكلة الأمّ هي هذه، وليس كيف نجعل السيارات أكثر ذكاءً واستقلالية بحيث تقود لوحدها ونحن مرتاحون. كان يجب علينا – كجنس بشري – أن نحل مشكلة “لماذا النقل العمومي سيء”؟ بدلًا من أن نسمح لكل شخص بامتلاك سيارته. يجب ألّا يمتلك أحدٌ سيارة داخل المدينة، في الواقع، يجب ألّا يكون هناك طرقات أصلًا داخل المدينة إلّا على حدود ضيقة وفق الحاجة.
إذا لم يكن هناك طرقات كثيرة، ولن يكون هناك سيارات، فكيف سنتحرّك إذًا؟ ببساطة: عبر استخدام نقل عمومي لا يقرف ويوصلك إلى المسار المطلوب بأسرع وقت ممكن، وعبر جعل الوسيلة الوحيدة للانتقال من مكان إلى آخر هي عبر النقل العمومي الممتاز. هذا ما يجب أن نعمل على إيجاده.
تعمل شركة تيسلا حاليًا مثلًا على إمكانية نقل الناس بمسافة 430 كيلومتر في 30 دقيقة، أي أقل مما أحتاجه للوصول إلى جامعتي التي تبعد عني 8.5 كيلومتر. ألا يوجد عاقل في مراكز صناعة القرار ليفكّر الآن في نفسه ليستنتج أنّه ربّما، ربّما فقط لدينا مشكلة في النقل؟ مالذي سيكلف أي دولة لإنشاء شبكة مواصلات تحتية مثل Hyperloop ولكنّها تغطي كل نقطة في المدينة وتنقل الناس فقط في مكوكات/كبسولات بدلًا من السيارات؟ أليس العمل على شيء مثل هذا، ثم التخلّص من الباصات والسيارات والطرقات والحاجة إلى رخص القيادة وإشارات المرور والضجيج والغبار والتلوث والوقود وووو…. كل الأشياء التي عملناها على مدار قرن ونصف من الزمن فقط من أجل السيارات سيكون أفضل؟
لكن المشكلة أعقد من هذا. المشكلة هي أننا كدول غير قادرون على اتخاذ مثل هكذا قرار لأسباب طويلة عريضة تبدأ بالرأسمالية وتنتهي بالديموقراطية. شركات السيارات ستحشد لعمل لوبي (Lobby) لمنعك عبر الديموقراطية من الحصول على الأصوات التي تحتاجها لتمرير شيء مثل هذا لأنك ستنهي الحاجة إلى وجودهم، والناس المتخلّفون سيفضل كل واحد منهم الاحتفاظ بسيارته على باب بيته بدلًا من إراحة الجنس البشري كمجموع، والقطاع العام الضعيف لا يمتلك لا قدرات بحث علمية ولا هندسية لتطبيق شيء مثل هذا على مدينة مثل اسطنبول يسكنها 15 مليون إنسان. دعك من تفاصيل فكرة النقل العمومي الممتاز الخرافي، لأنّك حتى لو أنهيت كل التفاصيل فستظل الفكرة فكرة ولن تحصل بسبب القيود التي وضعناها على أنفسنا كمجتمعات بشرية.
البشر لا يدركون أنّ التكنولوجيا والأتمتة والاختراعات التي وصلنا لها اليوم قادرة على تحويل حياتهم إلى جنّة، لكنهم يستمرون في حروبهم الصغيرة بين هذا الحزب وذاك، هذا فضلًا عن صنّاع القرار المترهّلين الذين لا تمتلك عقولهم قدرة على إدراك شيء مثل هذا. ولا حاجة لأن أذكر لك مشاكل الفساد والتدخّلات الخارجية وأمور طويلة عريضة كلّها تعيقنا عن تحقيق ما نحن قادرون عليه.
هذا فقط مجرّد مثال على حلّ البشر للمشاكل الخطأ، لكنك إذا تأملت في الواقع من حولك ستجد الجنس البشري يسعى بعبث لحل الكثير من المشاكل الخاطئة كذلك في مختلف القطاعات بسبب العوائق السياسية والاجتماعية والعرقية التي فيه.
كذلك بيروقراطية الدولة التي توظّف 2 مليون موظف فقط من أجل التوقيعات واتخاذ قرارات تافهة وإضاعة أوقات الناس والتي كان يمكنها عبر الأتمتة التخلص منهم جميعًا ثم إعطاؤهم مدخول شهري مجاني يكفي لسد حاجياتهم بدلًا من ذلك، كل هذا لن يحصل.
التمعّن في الحياة من وجهة نظر مهندس ومصمم رائع. إنّه يؤكد لك أنّ خالق هذا الكون أبدع في تصميم هذا الدين وقواعده وحلاله وحرامه ثم ما أن تجد البشر يعبثون في الكون دون الاستمساك بشيءٍ من شرع ربهم يتيهون فيه ويضرون أنفسهم أكثر من نفعهم إيّاها، ويحلّون مشاكل هم أنفسهم السبب فيها. اقرأ في سير سلف الأمّة وستجدهم كان يكرهون مضغ الطعام لأنّه يضيع أوقاتهم وأعمارهم، وأجد صعوبة في تصديق أنهم سيسرّون بالهراء الذي نعيشه اليوم في النقل. ولكن أعمى البصيرة لا يدرك أنّ من جعل الدين كاملًا في التشريع لن يغيب عنه أن يجعل تبعات اتباع هذا الدين هي الطريقة المثلى للعيش في الحياة الدنيا. أظننت أنّه يحكم العقيدة والفقه والصلاة، ثم يتركك تتوه وتخبط بعشواء في بقية حياتك الدنيا ولا يعبئ بما تفعله وتتبعه أيفيدك أم يضرك؟
وجدتُ هذا صحيحًا في الكثير من الأفكار الأخرى، حيث يجعل الله تعالى عقاب المرء الذي لا يتبع هديه هو نفسه ما يريده ذلك الشخص ويبغيه. فعقاب اتباع الربا هو نفسه ما تعانيه المجتمعات اليوم من الديون والفائدة ونقص بركة المال والفقر وانعدام التوزيع العادل، رغم أنّ الناس إن سألتهم اليوم في الشارع هل تريدون هذا أم شيئًا آخر، لقالوا لك نريد هذا والـ2% زيادة في نهاية الشهر ثم لا يعنينا شيء. عقابهم هو نفسه ما يبغونه، وهم عميان لا يرون أنّ المزيد من هذا هو نفسه ما يحذرونه.